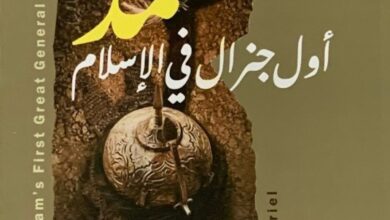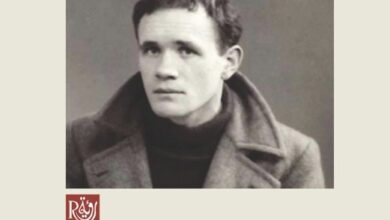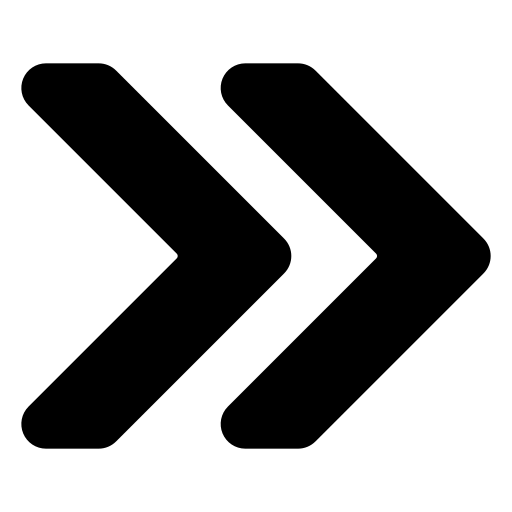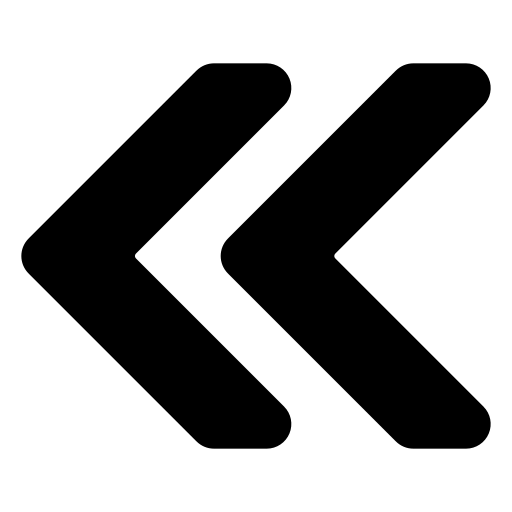كتاب طبيبة في بيت البرزنجي pdf
كتاب طبيبة في بيت البرزنجي
عدد التقيمات : 0
المؤلف
اللغة
العربية
الصفحات
0
حجم الملف
عن الكتاب
إن فتاة بجسارة كالالوفا وعزمها على خط مصيرها بنفسها تستحق اهتماماً استثنائياً. لقد قررت وهي في عشرينات عمرها، وفي عشرينات قرننا الذي يطوي صفحاته الأخيرة، أن تتوجه إلى الشرق من دون الركض وراء سراب النزعة الغرائبية.إنها ذاهبة إلى الشرق لتدريس أمراضه ولتكون عوناً له، وليس حباً في غرابته أو توقاً إلى وطن “ألف ليلة وليلة” وانجراراً وراء سحره، كما فعل عدد من أدباء الغرب، ولا طمعاً في ثرواته الدفينة كما فعل ويفعل المستعمرون منذ نهاية حركة الاستكشاف الجغرافي في القرن الخامس عشر وما تلاه حتى هذه الأيام. لقد هزأت بالصعاب، ولم تكن قليلة أو هينة. وكانت من الثقة بالنفس بحيث نفذت حلمها فأقامت لها “أول مستوصف تشيكوسلوفاكي” في بغداد منتصف العشرينيات.خالطت الناس وعاشت في وسطهم، وقدمت المساعدة الطبية لهم، وابتهجت لأن البغداديين تقبلوها واحدة منهم، فلم تعان الاغتراب. وفي الوقت نفسه عرفت مجتمع النخبة المثقفة العراقية وكذلك صفوة مجتمع الأجانب الصغير والمغلق، والذي حذرت منه فيما بعد، غير أنها تزوجت منه، تزوجت ذلك الإيطالي ذا الأصل النبيل، المحب للموسيقى والعارف بكل شيء والذي بدا للوهلة الأولى مترفعاً. وعلى شيء غير قليل من الغطرسة.كانت معرفتها باللغة العربية قد ميزتها عن الآخرين، كما أن تفهمها لطبيعة المجتمع العراقي وتقاليده في بداية القرن قد هدم أمامها آخر السدود، وهي تعي أهمية ذلك فتقول للدكتور ياروسلاف سليبكا في صيف 1962، وكان من المقرر أن يسافر في خريف ذلك العام إلى بغداد للعمل في رئاسة معهد التشريح المجهري: “تقولون أن هناك خمسين أو ستين من أبناء بلدنا؟ هذا شيء ممتاز. غير أن الإنسان ينبغي أن لا يحصر نفسه في عنين الأقلية. هذا ما فعله الإنكليز في العراق، ولهذا لم يستطيعوا مطلقاً فهم هذا البلد. ينبغي أن لا يحصر الإنسان نفسه في عنين الأقلية. هذا لب الموضوع. كانت كالالوفا لا تطيق نظرة التعالي لدى الأوروبيين إزاء المجتمع العراقي.لقد نجحت المؤلفة في تصوير أجواء المجتمع البغدادي في منتصف العشرينيات وحتى الثلاثينيات . ويحس القارئ روعة هذا الوصف ودقته في أماكن عديدة من الرواية وبخاصة الأجزاء الأولى منها. وهذا يعود بالدرجة الأساس إلى وصف الطبيبة كالوفا لهذه الأجزاء، ناهيك عن تصويرها بالكلمة واللمحة والموقف، وخصوصاً وصفها للجو الملحمي في الكاظمية في أثناء مرور موكب عاشوراء والتقاطها لتقاليد الطائفة الشيعية.