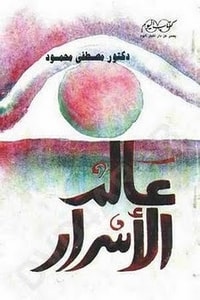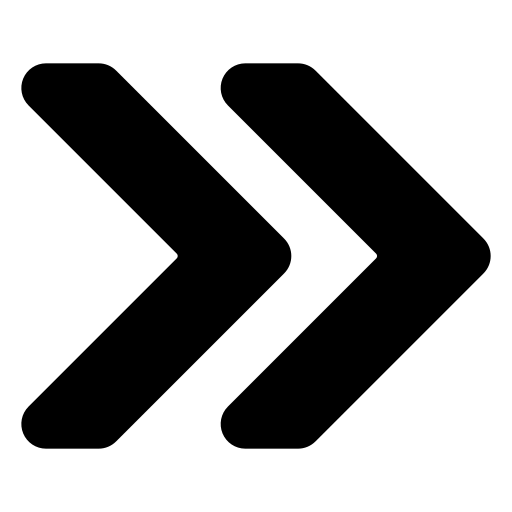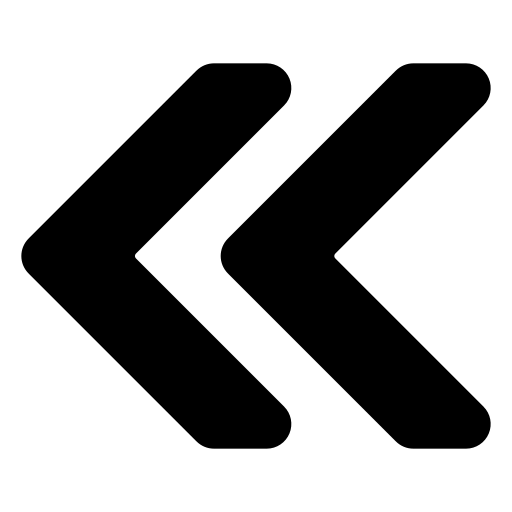كتاب الفلسفة الحديثة والمعاصرة pdf
كتاب الفلسفة الحديثة والمعاصرة
عدد التقيمات : 0
المؤلف
قسم
اللغة
العربية
الصفحات
306
حجم الملف
MB 5.41
عن الكتاب
ولو كان في استطاعة الفيلسوف أن يقدم حلولاً أكيدة لمشكلات الإنسان الدينية والأخلاقية, لقدم بذلك خدمة جليلة للبشرية, إلا أنه حتى تلك الأمور لا يملك شيئاً محسوساً يمكن أن يقدمه, لذلك كان من السهل أن ندرك أننا حين نقرأ الفلسفة إنما نكون إزاء جدل لا نهاية له, بل ربما يدور بين أناس ليس لديهم من المناهج ما يكفل لهم الاتفاق على شيء, بل ربما أنهم ليسو حريصين على هذا الأمر. ولذلك يبدو الفيلسوف وكأنه شخص يعيش بمعزل عن الناس, لا يشاركهم لعبة الحياة, بل يكتفي بالفرجة عليها. وهكذا بدت الفلسفة – في نظر الكثيرين – موضوعاً بعيداً بمشكلات عن الواقع, وبدأ الفلاسفة وكأنهم قوم انعزلوا بأفكارهم, أو انعزلت بهم أفكارهم, عن الحياة كما يعيشها غيرهم من الناس, وأقاموا لأنفسهم أبراجاً عاجية ينظرون منها بكبرياء إلى العالم الفعلي ويحكمون عليه أحكاماً متعالية, ويفسرونه بتفسيرات لا تكاد تكون مفهومة لسواهم مستخدمين في ذلك ألفاظاً غريبة غير متداولة إلا في أحاديثهم وكتاباتهم, ولكنها تبدو حين توضع بين الألفاظ المألوفة رموزاً لا تحمل معنى, وعبارات أعجمية لا يخرج منها الإنسان (العادي) بشيء مفهوم. وفضلاً عن ذلك, فإن الفيلسوف يبدو إنساناً غريباً, إذ يقرر أشياء لا يجد أي شخص آخر نفسه في حاجة إليها, وتثيره مشكلات لا تبدو لأحد غيره مشكلات على الإطلاق, فحينما يأتي الفيلسوف ليهتم – مثلاً – بالأفكار الأخلاقية, فإنه لا يقنع بتوضيح الطريقة التي نعمل بها الشيء الصحيح, بل لابد له أن يسأل أيضاً عما إذا كان فعل الشيء الصحيح والعمل الأفضل؟ وحينما يتعرض لبعض المسائل التي تتعلق بنظرية المعرفة فإنه لا يريد أن يكتفي بمعرفة الأمور التي يقوم بفعلها الآخرون, بل يريد أيضاً أن يعرف الطريقة التي يتكلم بها إلى الآخرين حينما تكون لديه معرفة وحينما لا تكون لديه هذه المعرفة. وهكذا ارتبطت الفلسفة في أذهان الكثيرين بالتعقيد, فضلاً عن بعدها عن الواقع كما يعيشه الناس, وعن الحياة كما يحياها غيرهم من عباد الله. هذا الحكم على الفلسفة إنما يعكس سوء الفهم الذي يحيط بطبيعة الفلسفة, وموضوعها, ومنهجها, ونوع النتائج التي تبغيها, ولكنه حكم ليس في الحقيقة بدون مبرر. ولنبدأ أولاً بصفة التعقيد التي ترتبط عادة بالفلسفة. لابد لنا أن نعترف منذ البداية بأن الفلسفة, شأنها في ذلك شأن العلوم المختلفة, ليست موضوعاً سهلاً يمكن لكل فرد أن يفهمه بيسر وبساطة, بل هو موضوع يتطلب لمعرفته قدراً من الجهد الفكري والمشقة العقلية مثله في ذلك مثل الفنون والعلوم. فلكل علم وفن لغته ومصطلحاته الخاصة التي يتعين على الدارس منذ البداية معرفتها وإتقانها, وبدون ذلك يعجز عن تحقيق أي تقدم في معرفة هذا العلم أو ذلك الفن. فالموسيقى مصطلحات فنية لابد من معرفتها لدارسي الموسيقى. فلو قيلت هذه المصطلحات لمن لا معرفة له بهذا الفن لبدأ الأمر معقداً إلى حد بعيد بالنسبة لصاحبنا هذا, ولبدت الموسيقى بالنسبة له أبعد ما تكون عن الفهم. ولعلم الكيمياء مصطلحاته ولغته, ولعلم الفيزياء لغته الفنية, وكذلك بقية العلوم الطبيعية والإنسانية, ولاشك في أن إتقان معرفة هذه المصطلحات واستخدامها بطريقة صحيحة يتطلبان جهداً كبيراً لابد أن يكون ماثلاً أمام كل من يبغي معرفة من هذا القبيل, أو تخصصاً في علم من هذه العلوم, أو فناً من تلك الفنون. ومثل هذا يمكن أن يقال عن الفلسفة, فلها بالتأكيد مصطلحاتها وموضوعاتها التي يقتضي تحصيلها قدراً من الجهد والمعاناة. ولكن يبدو أن صفة التعقيد قد جاءت من أن القارئ للفلسفة يتوقع عادة أن يلم بأطراف الموضوع كما يلم بمحتوى قصة من القصص الأدبية, أو خبر من الأخبار المألوفة. ولكنه سرعان ما يفاجأ بأن موضوع الفلسفة أعم وأدق مما كان يتوقع, وينطوي على كثير من المصطلحات الخاصة التي يتطلب فهمها قدراً من الجهد الفكري الذي قد لا يكون مستعداً لبذله, فيتهم الفلسفة بالتعقيد والصعوبة البالغة. كما يبدو أيضاً أن بعض الفلاسفة أنفسهم قد ساهم في ترسيخ وصف الفلسفة بهذا الوصف, فقد لجأ بعضهم بطريقة مقصودة أو غير مقصودة إلى عرض آرائه بطريقة تنطوي على قدر كبير من الغموض, بحيث أصبح فهم هذه الآراء أمراً بالغ الصعوبة, ومن أمثال هؤلاء الفيلسوف اليوناني القديم هيراقليطس, والفيلسوف الألماني هيجل, والفيلسوف الوجودي هيدجر, والفيلسوف التحليلي فتجنشتين الذي كتب في مقدمة كتابه "رسالة منطقة فلسفية" يقول: "لن يفهم هذا الكتاب – فيما أظن – إلا أولئك الذين كانت قد طرأت لهم الأفكار نفسها الواردة فيه, أو طرأت لهم على الأقل أفكار شبيهة بها. وأنه ليحقق الغاية منه لو أمتع قارئاً واحداً قرأه وفهمه". وليس هذا الأسلوب بالطبع هو الأسلوب الفلسفي المتبع عند جميع الفلاسفة بل كان معظمهم يكتب بأسلوب جميل وسلس, بل ومنمق في كثير من الأحيان, مما جعل بعضهم جديراً بنيل جائزة نوبل في الأدب مثل الفيلسوف الإنجليزي المعاصر برتراند رسل.